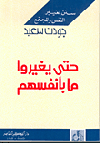ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ
من Jawdat Said
محتويات
ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ
قلنا فيما سبق أن التغيير الذي ينبغي أن نهتم به هو الجانب الذي يقوم به القوم من تغيير ما بالأنفس. فإذا كان مجال الأقوام في التغيير هو مجال ما بالأنفس، فعلينا أن نتبصر في هذا المجال الذي يخص الإنسان من التغيير. إن ما بالنفس يختلف في الرسوخ ولذلك كان تأثيره على ما بالقوم متفاوتاً في القوة والضعف. وهناك عوامل لترسيخ ما بالنفس منها، التكرار في العرض والشرح، والممارسة العملية لها في الحياة التطبيقية.
كثير مما بالنفس يعمل آلياً حين يكون راسخاً
ويمكن أن يقارن الموضوع بمثال آخر. فإن جسم الإنسان مركب من أعضاء تعمل لا إرادياً، مثل عمل القلب والرئتين والمعدة وإفرازات الغدد، ولو أن عمل هذه الأعضاء كان إرادياً، لكان الجهد الذي تتحمله الإرادة الواعية والفكر جهداً شاقاً. ولما أمكنه التفرغ إلى التفكير في مجالات أخرى تتعلق بنمو الإنسان الفكري. ولكن الله سبحانه وتعالى، أعطى لجهاز الفكر عند الإنسان تخفيفاً في المهمات، حين جعل عمل كثير من الأعضاء آلياً.
كذلك في مجال ما بالنفس، يمكن أن نلاحظ أن النفس تقوم بهذه العملية، من جعل بعض الأفكار تعمل عملها آلياً وذلك حين ترسخ وتتعمق فتصير هذه الأفكار تعمل آلياً دون الحاجة إلى استحضار فكر. فمثلاً حين نتكلم ونعبر عن المعاني بالعبارات، ويتداخل في هذا العمل الوعي والآلية، فإن استحضار الكلمات يكاد يكون آلياً دون جهد فكري، كلما كانت الكلمات راسخة ومستخدمة كثيراً، وهذا متفاوت أيضاً.
وإن الانتباه إلى مجالات ما بالأنفس من الوعي، وما تجاوز الوعي، إلى أن صار جزءاً عميقاً في النفس يعمل وكأنه مستقل عن الوعي. إن الانتباه إلى هذا التفاوت، وعوامل الترسيخ، وملاحظة أثر مرحلة الطفولة في ترسيخ الأفكار والمفاهيم، وما تعارف عليه الناس من أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إنما هو مبني على ملاحظة لها أثرها. وذاك الانتباه يفتح أمامنا آفاقاً في مجال تغيير ما بالنفس. فالخبراء الذين لاحظوا تجارب البشر، عندهم من المعرفة بهذه الأمور ما ليس عند غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلاً في كيفية ترسخ الفكرة، أو تمكنها حتى تصير ملكة، تتولد منها أعمال الإنسان وواقع المجتمع:
(عن حذيفة عن رسول الله ص قال: « تعرض الفتن على قلوب كالحصير، عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاة فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مُر بَادَّاً كالكوز مُجخَّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ». رواه مسلم. قال ابن جرير: فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: « ختم الله على قلوبهم ».
ونظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب، من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها)(1).
هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يضرب المثل في الرسوخ في جانب كل من الخير والشر، إلا أن الختم والطبع استعمل في جانب الشر، والخطأ الذي ترسخ وتعلق بالقلب، فضرب المثل بأشياء محسوسة للأشياء التي لا تحس أو للأمور المعنوية، وذلك بذكر مثل الحصير، وكيف تعرض الأعواد عند نسجها عوداً عوداً، فبناء النفس كذلك إنما يتم خلال الزمن، بعرض الأفكار عليها بوسائل مختلفة فكرة، فكرة. والقلب الذي يتقبل الفتنة والشر، تنكت فيه نكتة سوداء، والذي يرفض يبقى أبيض لا تضره فتنة. وكذلك العرض المستمر المتتابع على القلوب كنسج الحصير. هذا الحديث في مجال كيف يرسخ ما بالنفس، ويصل رسوخ ما بالنفس إلى درجة النسيان، ولكن هذا النسيان والغياب عن الوعي لا يجعله يكف عن التأثير على عمل الإنسان وسلوكه بل يبقى مؤثراً ولو كان خارجاً عن الوعي.
وهنا يمكن أن يشبه ما يحدث في النفس – من أن النفس تحول بعض الأفكار إلى الأعماق، مما يجعل هذه الأفكار تعمل عملها آلياً – بما يحدث في بعض أعضاء الجسم عند الإنسان التي تعمل آلياً، كذلك الأفكار المترسبة في الأعماق تعمل آلياً وتستجيب للأحداث والمثيرات استجابة آلية، ولا يشترط أن يكون كل ما ترسخ صواباً بل الخطأ أيضاً يترسخ، وقد يكون الصواب فيه قليلاً.
ونبش هذه المفاهيم المترسبة وإخراجها إلى حيز الوعي، وإجراء التغيير اللازم عليها عملية ليست خارجة عن طوق الإنسان، لأن ذلك من المهمة التي أوكلها الله إلى الإنسان لا كفرد، بل كقوم وكمجتمع.
كشف سنن التعامل مع النفس يجعل تغيير ما بها سهلا
إن تغيير ما بالنفس، سواء كان في مجال الوعي أو كان مترسباً منسياً بكل محتوى النفس الظاهر والباطن، إن هذا التغيير من مهمة الإنسان، وكلما كشف سنن التعامل مع النفس كان قادراً على إحداث التغيير. فمن هنا تتأكد الحاجة إلى ضرورة تحصيل علم سنن تغيير ما بالنفس.
وفي مجال أهمية الطفولة في ترسيخ العقيدة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه …) وقد سبق أن بينا معنى الفطرة. وأما أن الأبوين يقومان بمهمة ترسيخ العقيدة، فإن الطفولة تمتص هذه العوائد والمفاهيم والقيم، تمتص مالا ينطق به الأبوان أو المجتمع، مما يستنبطه الطفل من الأذواق والاستحسان والاستقباح لأمور كثيرة لا يشعر بها الطفل، وإنما يتشربها تشرباً، ويوحى بها إليه إيحاء، مما يؤثر في سلوكه في كبره دون إرادة منه، ولاسيما في اللحظات التي لا يتيسر فيها إعمال الرأي، وفي اللحظات الحرجة التي ينبغي فيها أن يتخذ قراراً، أو يختار أمراً، فهنا عوامل السوابق التاريخية الماضية تؤثر في اتخاذ الاتجاه المعين، لأن دخل الإرادة فيه قليل، أو ينعدم. فهذا معنى الختم والطبع، حين يحدث الشلل للفكر الواعي ويعجز أن يسيطر على تصرفه، فيستلم الزمام ما ترسب من الأفكار، وهذا ما يسمى بالعواطف والانفعالات. فالعواطف هي الأفكار المترسبة، والانفعالات هي آثارها العملية. وعلينا أن نعرف أن الشخص حين يقوم بعمله، فهذا العمل الذي يقوم به ليس مصدره فقط الفكر الواعي، وإنما يشترك فيه أيضاً الأفكار المترسبة التي نسيت، ولكنها لم تُفقد بل ظلت تؤدي دورها بأرسخ مما كانت.
وقد تنبه ابن خلدون إلى شيء من هذا حين تحدث عن اكتساب ملكة البيان العربي والشعر، قال: « فمن قل حفظه أو عَدِمَ لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط، واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ. ثم الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ … ». وموطن الشاهد من كلام ابن خلدون ليس هذا بل سيأتي وهو قوله: « وربما يقال إن من شرطه نيسان ذلك المحفوظ، لتحمى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها، وقد تكيفت النفس بها، انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة »(1).
وما يقوله ابن خلدون لا ينطبق على الشعر فقط، بل على كل علم من العلوم إذا أراد الإنسان أن يكسب ملكة فيه.
وكذلك إتقان لغة التخاطب إنما يكون في عهد الطفولة، وإتقانها بعد الكبر كأهلها أصعب، فهذه كلها راجعة إلى سنن تغيير ما بالنفس. فكما أن أهل اللغة الواحدة يتكلمون لغة واحدة، كذلك أهل الثقافة الواحدة والنمط الموحد في التفكير، يفكرون بأسلوب واحد من التفكير، وكذلك أذواقهم وما يميلون إليه وما يكرهونه وما يقدرونه وما لا يبالون به. وكما بين الأفراد فروق فردية، كذلك بين الأمم والمجتمعات، إلا أن مصدر الفروق مختلف، إذ مصدره في الأفراد الفطرة والاستعداد الأولي، بينما في المجتمعات مصدره مقدار استغلال هذه الاستعدادات. فالأول موهوب والثاني مكسوب. والخلط بينهما يكون سبباً لتبني العصبيات التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها منتنة.
والفطرة الموهوبة للأفراد من الذكاء تتفاوت، وهذا التفاوت فطري موجود في كل مكان بين الأفراد، في كل المجتمعات، وحتى بين الاخوة من متوسطي الذكاء ومن هم دون ذلك أو فوقه. ولكن المجتمعات ليست هكذا بالفطرة، بل ما بين المجتمعات من الفروق إنما ترجع إلى مواريثهم المكتسبة من الثقافة، فبهذا يتفاوتون. ويمكن لكل مجتمع أن يرفع أو يغير بين من نشأ في المدينة والقرية، والطبقة المعنية، وإن كانت وسائل الثقافة الآخذة في التطور والانتشار تقلل من الفروق. فكل مجتمع فيه من الأفراد نسبة معينة من الممتازين والمتوسطين والمقصرين بالفطرة. وما يمكن أن يطرأ على مجتمع ما من رفع المستوى يمكن أن يطبق على كل المجتمعات.
ولا توجد بين المجتمعات فروق في الفطرة وإنما فروق في الثقافة المكتسبة، وهذه تقبل التغيير ارتفاعاً وانخفاضاً. لهذا كما يمكن أن يكون تطور مجتمع ما إلى الأمام، يمكن أن يكون تغيير مجتمع آخر إلى الوراء. كما يمكن أن يحدث تغيران في آن واحد في مجتمع واحد، كأن يحدث تغيير في جانب إلى الأمام، وتغيير آخر إلى الوراء، وتفيد معرفة هذا حتى يمكن تمييز ما فيه تقدم وتأخر.
إن هذه المواضيع لم تصر في العالم الإسلامي علماً تطبيقياً، وإن كان شيء من ذلك، فهي نظرات عند أفراد قلائل لم يصلوا بعد إلى درجة سد فرض الكفاية في الأمة. ولا بد أن يصل عدد هؤلاء علماً وعملاً إلى ما يسد حاجة الأمة، حتى يمكن اختزال زمن التغيير إلى أدنى حد.
ولكن إلى الآن لم تصح عندنا الفكرة نظرياً، فضلاً عن أن نستخدم ذلك في سبيل تغيير ما بالأنفس لنغير ما بالمجتمع، ولا مؤسسات تقوم بمهمة التغيير ومراقبة السير على أساس علم منهجي. ويحول دون ذلك أفكار معينة مترسبة في أعماقنا، اعتماداً على القضاء وتحقيراً لقدرة الإنسان وجهده.
ويمكن أن نقرب الفكرة قليلاً، إذا قارنا عملية التغيير فيما بالأنفس بعملية تعليم القراءة والكتابة، فلو ترك تعليم المجتمع القراءة والكتابة، إلى مجهود كل شخص دون أن تكون مؤسسات لتعليم أطفال الأمة، فإن الفوضى ستحل. وكذلك ينبغي أن يخضع تغير ما بالأنفس لمؤسسات. وإلى الآن يحدث ما يحدث عندنا على أساس الصدفة، دون تحول ذلك إلى علم منَّهج واضح. لهذا يظهر عدم التوازن في المجتمع وبطء نموه حتى في المشاكل التي صارت خاضعة للسنن بوضوح في مجتمعات أخرى. والسبب ؛ أن الأمة لم تحصل بعد ملكة تغيير ما بالأنفس، ولم تملك ما يسد فرض الكفاية. ونقص ملكة التغيير، مثل نقص ملكة البيان والشعر، فلا يمكن تحصيل ملكة عملية تغيير ما بالأنفس – كما لا يمكن تحصيل ملكة البيان والشعر – إلا بممارسة هذا الفن ؛ وهو النظر في سنن الماضين وما حدث للأمم من تغيير بطيء أو سريع خلال التاريخ. ونحن إلى الآن لا ندرس التاريخ على هذا الأساس أو القصد، وإن كان القرآن يلح علينا في ذلك.
وفقدان هذه الملكة مشكلة عامة في الأمة في مختلف طوائفها، لأن هذا المرض عام إذ هو مرض مجتمع لا مرض طائفة معينة ولا مرض فرقاء. ولو أن هذا النظر صار بضاعة للمجتمع، لتمتع به من يعيش في هذا المجتمع مهما اختلفت نظراتهم.
وهذا ما يفسر تنازع من هم أقرب لبعضهم في النظر، في المجتمعات المتخلفة، ومن هم على هدف واحد وأيديولوجية واحدة. بينما المجتمع، الذي حصل لديه ملكة فن التغيير، لا يبلغ النزاع فيه بين المتضادين في وجهات النظر، ما يبلغ النزاع فيه بين المتفقين في وجهات نظرهم، في الأمة التي لم تمتلك بعد مثل هذه الملكة. وواقع البلدان المتخلفة أو التي تسمى تفاؤلاً نامية، أصدق شاهد لمن أمكنه أن يتأمل.
أعمار المجتمعات والدول ورأي ابن خلدون
وابن خلدون لاحظ سنة التغيير بوضوح في أعمار الدول، وإن كان يفهم من تفسيره لها أنها حتم، ولكن الأمر ليس كذلك، ولاسيما وقد ملك الإنسان من وسائل التربية ما يطوع عملية صياغة الإنسان.
ولابن خلدون العذر في أن تكون عباراته غير دقيقة، حيث جعل مرد ذلك إلى العوائد المترسخة، التي يمكن أن تمثل ما نطلق عليه نتائج ما بالأنفس. قال في « فصل إن الدول لها أعمار طبيعية كما للأشخاص ». وبعد أن تحدث عن عمر الأفراد، تحدث عن عمر الدول فقال: (إن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال، والجيل هو عمر شخص واحد، والعمر الوسط يكون أربعين. وعلل ذلك بأن الجيل الأول، لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها.. والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة. أما الجيل الثالث فينسون البداوة والخشونة كأن لم تكن فيصيرون عيالاً على الدولة. فهذه كما ترى ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها.
ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن المجد والحسب إنما هو في أربعة آباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كافٍ مبني على ما مهدناه من قبل من المقدمات. فتأمله فلن تعدو وجه الحق إن كنت من أهل الإنصاف.
وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مئة وعشرون سنة على مر ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر. بتقريب قبله أو بعده إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان الطالب فيكون الهرم حاصلاً مستولياً والطالب لم يحضرها ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »)(1).
وأطال ابن خلدون هذا البحث، ومهما يكن فإن سبب ذلك راجع إلى تغيير ما بالأنفس من النظر إلى الأمور. ولقد وضح ذلك فقال: (إذا كان الهرم طبيعياً في الدولة، كلن حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني. وقد ينتبه كثير من أهل الدولة ممن له يقظة في السياسة فيأخذ نفسه بتلافي ذلك … ويحسب أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل الدول وغفلتهم، وليس كذلك فأنها أمور طبيعية للدولة، والعوائد هي المانعة له من تلافيها). وقد بيَّنا أن هذا صحيح في آخر الأمر، ولكن هذا يمكن أن يُمنع حدوثه إذا أُخذ بأسبابه وسيطر عليها البشر، ولاسيما قبل أن يحل الطبع على القلوب. والذي يقرب هذا المعنى كون ابن خلدون نسب الأمر إلى العوائد. والعوائد قابلة للتغير أحياناً طبيعياً وأحياناً صناعياً. وهذا ما خفي على ابن خلدون، مما أمكن تفسير اتجاهه إلى الحتمية.
وقتال ابن خلدون عن العوائد « … وللعوائد منزلة أخرى طبيعية، فإن من أدرك مثلاً أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج، ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب، ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات، فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك، إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالناس. إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه. ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتها لولا التأييد الإلهي والنصر السماوي.
وربما يحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها ويومض ذبالها إيماضة الخمود، كما يقع في الذبال المشتعل فانه عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة تُهم أنها اشتعال وهي انطفاء.
فاعتبر ذلك، ولا تغفل عن سر الله تعالى وحكمته في اطراد وجوده على ما قدر فيه و« كلل أجل كتاب »)(1).
وما يقول عنه ابن خلدون: بأنه عوائد تمنع تلافي نتائجها ويعتبرها طبيعة أخرى بحيث يرمي من يخرج عنها بالجنون والوسواس، وضرب المثل في ذلك بلباس الذهب والديباج.. ولكن ما بالك بأنماط التفكير والنظر إلى الكون والحياة والمجتمع، هذه الأنماط تتحول إلى عوائد، والانتباه إليها أصعب وأدق وبلواها أعم. وهذا هو الذي حدث للفكر الإسلامي في جموده خلال العصور وتوارثوه كابراً عن كابر، وكل من خرج عليه اتهم بالمروق.
وابن خلدون يضرب المثل في الدولة التي قدر عمرها بثلاثة أجيال، وكذلك المجد والحسب. فما بالك بدين عالمي يضم بين أحشائه الدول المتعاقبة، حين ينظر إليه بهذا المنظار، منظار أثر العوائد، وما يحدث من تغيير على طول الزمن من غير أن يشعر الناس به، ويتوارثها عشرات الأجيال مما يقلب كثيراً من الأمور عما كانت عليه سابقاً.
فإن كان ابن خلدون يقول: إن الجيل الثالث ينسى عهد الخشونة والبداوة كأن لم تكن … فما بالك بنسيان أنماط التفكير المتفتح للحياة. فلو أن مجتهداً اجتهد مثل الاجتهادات عمر بن الخطاب، لما أمكن تحمل ذلك، لا لأن الزمن لم يعد في حاجة إلى اجتهاد، ولا لأن مقتضيات ذلك الاجتهاد لم تحدث.
وهذا التغيير البطيء، تخفى على الناس كيفية حدوثه فيظنون أن الأمر لم يتغير، ولكت يرون النتائج تغيرت فيقعون في حيرة. ولا يدركون تفسير ذلك.
ومن أكبر المشاكل التي تعترض المسلم في هذا الموضوع، توهم الناس انهم في أنماطهم الفكرية مثل ما كان عليه الناس في عهد الصحابة، فيحاولون أن يروا في الرماد ناراً وفي الجمود حركة. فلا يميزون ما حدث من تغيير في الفكر والنظر، فيقيسون أنفسهم بهم دون شعور، وهذه مصيبة كبيرة وعقبة كؤود، تحول دون رؤية الأمراض التي تصاب بها المجتمعات.
وليس هنا مجال تفصيله الآن وإنما نشير إليه إشارة، وقد ذكر ابن خلدون ذلك فقال: « ومن الغلط الخفي في التاريخ، الذهول عن تبديل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الاعصار ومرور الأيام، وهو داء دوي شديد الخفاء. إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال العالم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج واحد مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال.
وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، كذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول « سنة الله التي قد خلت في عباده » غافر – 85 -(1).
وهذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوان ذهاب العلم، والصحابي لم يكن يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم، وكذلك لم يفهموا كيف نكون كالقصعة، يتداعى عليها الأكلة. أما نحن اليوم فلا نفهم كيف يحصل العلم، ولا كيف ننقذ القصعة المستباحة.
ذلك الصحابي لم يكن يقدر أن يتصور كيف يذهب العلم، واليوم نتعب التعب كله في إثبات وجود علم يخرج المسلمين مما هم فيه من التيه.
وكذلك حديث القصعة وتداعي الأكلة إليها، فإن الصحابة عجزوا أن يفهموا كيف يمكن أن يتم ذلك، وكل ما خطر في بالهم من تفسير للموضوع، أن يكون سبب ذلك قلة في عدد المسلمين، حين قالوا أوَمنْ قلَّة يومئذ يا رسول الله؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن العدد حين التداعي على القصعة يكون كثيراً. ولكن هناك شيء آخر يجعل الناس كغشاء السيل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى المستقبل من خلال السنن، ولم يكن كل الصحابة كذلك.
وليس هناك نظر اجتماعي سنني، مثل نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المشكلة الاجتماعية. وكما يقول مالك بن نبي كان رسول الله يقرأ التاريخ قبل أن يقع، ويحذر من الوقوع فيه، على أساس أن الأمر على نظام وسنن، سواء في الوقوع في الجهل والقصعة المستباحة أو الخروج منها.
إن هذا النظر السنني هو ما يحتاج إليه شباب العالم الإسلامي، إذ أن عدم وضوحه يحشر الأمور المختلفة في ميزان واحد، بينما يبعد الأمور المتشابهة عن بعضها. فيقع المرء في حيرة فيجعلنا مرة مثل الصحابة، ومرة مثل الجاهلين. ولا يدرك ما يميزنا عن كل واحد منهم من عناصر التخلف.
وقد بحث هذا مالك بن نبي، حين بحث عن إنسان الحضارة، وإنسان ما قبل الحضارة، وإنسان ما بعد الحضارة، وبين أن مشكلة إنسان ما بعد الحضارة، أعقد من مشكلة ما قبلها.
وأهمية هذا الموضوع هو الذي جعل ابن خلدون يقول: «الذهول عن تبدل الأحوال الذي هو داء دوي شديد الخفاء لا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة». وهذا هو الذي يجعلنا لا نقدر على كشف المشكلة التي نعيشها.
إنني أجدني اشعر بضيق شديد من خفاء هذه الأمور وعدم وضوحها، وأنها لم تصر بعد بضاعة مفهومة متداولة. وهذا الخفاء يعوق حركة التقدم في الإصلاح لما يحيط به من غموض. فما لم نسيطر على خارطة تغيير ما بالنفس، وما لم نتمكن بوضوح من سنة التغيير، وما ينبغي أن نغيره وما ينبغي أن نحذفه، وما ينبغي أن نضيف إليه ؛ سنظل في طريقنا بعفوية لا قصد فيها، ونحافظ على أفكار تعوق تقدمنا، وننبذ أفكاراً ونعاديها بينما لا غنى لنا عنها. مثال ذلك عدم مبالاتنا بعلم تغيير ما بالنفس، هذا فضلاً عن إعراضنا عن عبر التاريخ التي توضح لنا ما ينبغي أن نغيره. فهنا نحتاج إلى علمين، علم تغيير ما بالنفس، وعلم آخر وهو ما نميز به ما ينبغي أن نغيره مما ينبغي أن نبقيه. فهذا النقص هو الذي يجعل سير حركة المسلمين بطيئاً، مثقلاً بالآصار والأغلال التي تحول بينهم وبين أن يروا المستقبل في ضوء الماضي. إن الحيرة نتيجة الغموض، والحيرة هي البرزخ الذي نسير فيه في أيامنا هذه.
الجهل بكيفية التغيير وبما نغيره يجعلنا ننتظر المهدي
إن اندفاع الإنسان للحركة المجدية، مرهون باقتناعه أن لكل مشكلة طريقة لحلها. فكذلك المسلمون لا يمكن لهم أن يتحركوا بجدية لتغيير واقعهم، ما لم يقتنعوا أن مشكلتهم تخضع لقوانين وسنن.
أما إذا بقي لديهم شعور أن المشكلة لا تحل إلا بالمهدي، أو بأن الزمن شارف على الانتهاء، فان المشكلة تبقى دون حل، بل تزداد تعقيداً.
ربما يتضايق من هذا الوصف بعض القراء الكرام، وربما شعروا أنني أستخف بذكائهم، وينفون عن أنفسهم انتظار المهدي، أو أن يروا أن الزمن أشرف على نهايته، ويدعون أن هذا إيمان العوام. ولكن ما الخطة التي عند هؤلاء القوم الكرام لتغيير ما بأنفس هؤلاء العوام، حتى يرتفعوا عن مرتبة العوام إلى مرتبة من يشعرون أن سعيهم ليس سدى ولا عبثاً؟.
وما لم نتمكن من معرفة تغيير ما بالنفس، ومعرفة ما ينبغي أن نغير كماً وكيفاً، فسنظل ننتظر المهدي فعلاً وإن نفينا عن أنفسنا ذلك نظرياً. إن الإيمان بفكرة ما – بشكلٍ منحرف – يؤدي إلى مواقف سلبية.
ما زلنا في بحث تفاوت ما في النفس بالنسبة لرسوخه. وهنا أريد أن أوجز جانباً من هذا الموضوع عما بالنفس . إن الفكرة هي التي بالنفس، ولكن بعض الأفكار التي بالنفس، لا يشعر بها صاحبها. فأفكار الإنسان ليست حاضرة في كل لحظة، بل منها ما يحضر عند تداعي الأفكار، ومنها ما يحضر بالتذكر، ومنها مالا يتمكن صاحبها من استحضارها مهما كد ذهنه. ومع ذلك تدخل هذه الأفكار المنسية في توجيه سلوك الإنسان كما سبق أن أشرنا إليه.
الفكرة المتعمقة في النفس مصدر للأخلاق
وهنا يمكن أن ننظر إلى الفكرة على أنها تمر في مراحل لدى دخولها نفس الإنسان، وذلك من أول ما تصل إلى النفس إلى أن تتغلغل فيها وتترسخ. والفكرة بذاتها لم تتغير ولكن الذي تغير مقدار تغلغلها في النفس، ومقدار نتائجها في الواقع. ويمكن أن نمثل الفكرة بالإنسان ولو لم يكن التشابه كاملاً. فالإنسان في مرحلة ما يكون جنيناً، ثم يكون طفلاً، ثم فتى ثم كهلاً.. الخ.
ففي كل مرحلة يسمى باسم وهو في الأصل واحد. وكذلك الفكرة تمر بمراحل من نظرية وظن إلى إدراك وعلم فإلى سلوك وخلق … الخ.
إن الفكرة حين تتعمق في النفس تكون مصدراً للأخلاق، وما الخلق إلا السلوك الناشئ عن أفكار متعمقة ثابتة راسخة في النفس.
السلوك والأخلاق يحميهما العلم
وينبغي أن يلاحظ أن الفكرة يمكن أن يوحى بها، فتكون مصدراً للأخلاق دون أن تمر بالوعي الشعوري، كما عند الأطفال والعوام. وحين نفهم كيف يحدث هذا وما وسائل ذلك على أساس واضح. فمثل هذا الفهم هو الذي يجعل حماية الأخلاق بل إنشاءها بواسطة العلم ممكناً. لأن الخلق سلوك ظاهر، يكمن وراءه دوافع رسخت في نفس الإنسان، قد ننتبه إليها وقد لا ننتبه. ولن يصبر ذلك علماً ما لم ننتبه إلى ذلك ونحدده. وإن الذين يظنون أن الأخلاق لا تخضع للعلم، وأن العلم لا يؤثر فيها، لا يمكن أن يعترفوا بإمكان حماية الأخلاق فضلاً عن إنشائها، كما أنهم لا يكونون شاهدوا صلة العلم بالأخلاق.
وقد تكون الفكرة – كفكرة أولية – موجودة عند الإنسان، مثل الفكرة الموجودة عند الإنسان عن مشاهدة سقوط الأجسام إلى الأرض. فهذه كظاهرة، يدركها كل الناس، بل ربما لا يخطر لهم أن يفكروا فيها، وتذكيرهم بها يكون غريباً عليهم. فأصل الفكرة موجود عند كل فرد، ولكن فكرة العالم الفيزيائي عن سقوط الأجسام غير ما عند الإنسان العادي. فالعلم يمكن يرى في الموضوع عنصر الزمان والمكان والسرعة والكتلة وآثارها، ويمكن أن يحسب قوة السقوط والاختراق، ويمكن أن يبدع على أساسها أعمالاً مدهشة كبناء الجسور والطائرات والقذائف. ويمكن أن يمثل سقوط الأجسام، ومعرفة كل فرد بأصل الفكرة، وتفاوتهم في معرفة دقائقها وقوانينها، وما يترتب على ذلك، يمكن أن يقارن هذا، بفكرة الأخلاق في أصل المعرفة المجملة من قبل كل الناس. فكل الناس يسمعون ويتكلمون بكلمة الأخلاق، ولكن ما يمكن للعالم أن يكشف من قوانين وسنن نشأة الأخلاق وقيمها – كما فعل (هادفيلد) في كتابه: (تحليل نفسي للخلق) – إن معرفة هذا الإنسان لسنن الأخلاق، لا يمكن أن تقارن بمعرفة الإنسان العادي. وليس معنى هذا أن الإنسان العادي لا يمكن أن يملك أخلاقاً متينة. لا ليس هذا المراد، ولكن الإنسان العادي ليس في طوقه أن يحمي الأخلاق حماية علمية، ولا يمكن أن يملك ذلك، كما يمكن أن يكون بين الرجلين في المعرفة بونٌ لا يمكن أن يقارن بينهما، بل يتطلع إليه الإنسان العالم من الأمل في المستقبل لتسخير هذه السنن لا يتيسر لغيره. وأكثر الناس عندهم أصلٌ لفكرة « قل هو من عند أنفسكم » آل عمران – 165 -. ولكن هذا المفهوم الذي عندهم من الآية غير راسخ كما أنه غير واضح لهذا لا أثر له على سلوكهم.
وهنا نذكّر مرة أخرى بحديث زياد بن لبيد في دفع الشبهة مما يمكن أن يقال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا. إن تأمل حديث زياد بن لبيد يجيب عم هذا السؤال كما يجيب حديث القصعة. ولا شك أن الصحابة كلهم لم يكونوا في مستوى واحد في هذا الموضوع. كما أن تحول الخلافة إلى ملك عضوض وملك جبرية، إنما كان لضياع هذه السنن، أو لأنها تحولت إلى معرفة عامية، بدل من أن تظل معرفة علمية في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: « يحدث هذا أوانٌ ذهاب العلم ». إن الأصل الذي يحتوي عليه الحديث، ضروري ونافع في عامة البحوث، لذا أشعر بضرورة الإشارة إليه أثناء البحث في كل موضوع يحتاج إليه.
وقبل أن أختم البحث أنبه إلى ما سبق ذكره من أن كلام ابن خلدون عن العوائد، يوهم أنها غير خاضعة لسلطان الإنسان. والحقيقة أن هذه العوائد، تنشأ ثم تعمل عملها في حياة الإنسان والمجتمعات وفق سنن وقواعد، إذا عرفها الإنسان استطاع أن يتحكم بالعادات ويصرفها وفقاً لما يريد.
وموضوع العوائد ليس مثل الهرم الذي يصيب الإنسان. فالهرم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه لا دواء له هو هرم الإنسان، لأن هرم المجتمعات له دواء يمكن علاجه بعد أن يقع، كما أنه يمكن منعه قبل وقوعه، حين يسيطر الإنسان على سنن رسوخ الفكرة وسنن التغيير.
وفن تغيير ما بالنفس مهمة الإنسان كما بينا في هذا الكتاب.
وشيء آخر نريد التنبيه إليه، وهو أن العلم له مقام كريم في القرآن، وحين جعلنا عنوان هذا الفصل « ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ » كان مستندنا في ذلك قوله تعالى:
« وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » آل عمران – 7. إن لرسوخ العلم ميزة خاصة من المعرفة، أو كيفاً خاصاً للعلم، به يعطى الإنسان سلطاناً لا يتيسر لمن لم يرسخ في العلم. وإذا فهمنا أن العلم قابل للزيادة والرسوخ، زال تخوفنا من العلم، وزالت الفكرة التي طالما ملأت رؤوس المسلمين: أن العلم لا يؤدي إلى فهم الحق، ولا يحل مشكلة المسلمين. وما يقال عن العلم والأخلاق والثقافة من أنها متغايرة، سببه تفاوتٌ في رسوخ العلم وزيادته. وأصل التشويش الذي يحدث، هو أن السلوك في مرحلة من مراحل العلم، لا يتكيف مع العلم الذي حصل كالذي « أضله الله على علم » الجاثية – 23 – ولكن ليس عيباً في العلم، وإنما هو نقص في ترسيخ العلم، ونقص في صاحبه ينبغي أن يكمله لا لزيادة منه، والترسخ فيه.
« وقل ربِّ زدني علماً » طه – 114 -.
والمسلمون حين بحثوا الإيمان والإسلام، وهل الإيمان قول وعمل أم لا، إن هذا البحث أيضاً راجع إلى نفس المشكلة التي هي علاقة السلوك بالمعرفة، وهذه العلاقة درجات على حسب رسوخ العلم:
« قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» الحجرات – 14 -.
وعدم التنبه إلى تفاوت رسوخ العلم وزيادته، هو الذي أدى بالبعض إلى القول: إن هناك علماً ظاهراً وعلماً باطناً، أو علماً عادياً وعلماً لَدُنِّيَّاً، وإنما هو علم ناقص أو علم لم يرسخ. وقل: رب زدني علماً.